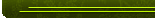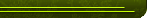على الرغم من المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتحييد وتهميش دور الوسطاء، تشهد المرحلة الراهنة تحوّلًا نوعيًا في دورهم. ويُعزى هذا التغير إلى الدعم الأميركي الواضح والتصميم المشترك للوسطاء العرب والإقليميين، مما منحهم قيادة أقوى وأكثر تأثيرًا.
ويتضح ذلك جليًا في النموذج المصري، حيث تجاوز دور القاهرة مجرد الوساطة ليصبح حاملًا للضمانات (السياسية، المالية، والأمنية)، ما يرسخ مكانتهم كأطراف ضامنة وليست مجرد ميسّرة.
ويفتح هذا الدور المتعاظم المجال أمام بحث إمكانية انضمام مصر وبعض الوسطاء الآخرين إلى التشكيل الأمني المستقبلي في
قطاع غزة، وهو الأمر الذي ما زالت طبيعته وكيفيته في مرحلة المداولات الأولية.
تبدو الإدارة الأميركية معنية هذه المرة بوقف الحرب، ورغم أنها شريك في العدوان على الفلسطينيين من بداياته، لكنها الآن تحاول أن تظهر بدور وسيط متزن إلى حد ما. وصحيح أن المصالح الإسرائيلية ستكون حاضرة، ولكن أيضًا هناك مصلحة لإدارة ترامب في عدم إفشال هذه الخطة الآن.
هناك أهداف وُضعت للخطة من المنظور الأميركي الإسرائيلي تتمثل في ضمان أمن إسرائيل، وتجريد المقاومة من السلاح، وإبعاد حماس عن الحكم، ووضع غزة تحت الوصاية الدولية لقتل فكرة حل الدولتين، والعمل على التحضير لدمج إسرائيل في المنطقة من خلال رفع الحرج عن الأنظمة التي ترغب
بالتطبيع معها.
إضافة إلى تحويل غزة إلى موقع اقتصادي استثماري دولي، وأن يكون طريقًا تجاريًّا بديلًا عن
قناة السويس أو طريق الحرير، ولهذا السبب تظهر الأبعاد اقتصادية بالدرجة الأولى، وتتحوّل الحقوق السياسية إلى امتيازات اقتصادية تسعى الإدارة الأميركية إلى تحقيقها.
باعتقادي؛ محاولات فرض الخطة على الأطراف واردة، وخصوصًا إسرائيل، فإذا ما بقيت الإدارة الأميركية معنية في الخطة؛ يمكن أن تلجأ إلى سياسة فرضها، لأنّ هذا يعتبر اختبارًا لإدارة ترامب.
الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني لهما حساباتهما الخاصة لعدم التصادم المباشر مع الإدارة الأميركية في هذه المرحلة، إضافة إلى وجود الضامنين الإقليميين الذي يشكل فرصة أكبر لفرض هذه الخطة. كما يظهر مسعى القوى الإقليمية بشكل كبير في إنجاح الخطة.
تظهر السلطة الفلسطينية مرونة قصوى وقبولًا للشروط المفروضة عليها، مدفوعة بتوقعها الحصول على مقابل سياسي في نهاية المطاف. وينعكس هذا القبول في استعدادها للوصول إلى تفاهم مع حماس بهدف توحيد الإدارة في غزة، والالتزام بخطة إصلاح وطني تشمل تنظيم الانتخابات، والموافقة على الخطة العربية الخاصة بنشر قوات عربية في القطاع.
ويبدو أن هناك توافقًا على ضرورة إطلاق حوار فلسطيني-فلسطيني لضمان بيئة مواتية لتنفيذ هذه الخطة الشاملة، مع ضمان تدفق المساعدات بضمانات سياسية عربية وإقليمية.

في المرحلة الأولى، اتبعت إسرائيل سياسة مزدوجة شملت التهديد والقصف المكثّف للضغط على حماس. لكن هدفها الأهم كان استدراج حماس للإفراج عن الأسرى بأقل ثمن، مقابل تمرير رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن إسرائيل ستواصل توجيه الضربات على غزة تحت أي ذريعة.
وقد تأكّد هذا المنهج بارتقاء أكثر من 80 شهيدا خلال أسبوعين من الهدنة، مما يشير إلى أنّ هذا هو الواقع المستقبلي لقطاع غزة الذي تسعى إسرائيل لفرضه. هذا الضغط الواضح، إلى جانب المطالبة بنزع السلاح، دفع حماس إلى الاعتقاد بأن إسرائيل تسعى لإطالة أمد المرحلة الأولى، للتمهيد لكمين سيأتي لاحقًا.
لم يكن لدى حركة حماس الكثير من الخيارات، ما اضطرها إلى التسليم بالواقع المفروض؛ حيث كان قبولها بمثابة استسلام، ورفضها يعني الانتحار.
استجابت حماس للضغوط الأميركية والعسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى رغبة الوسطاء الملحّة في تجنب استئناف القتال. وعلى الرغم من ذلك، سارعت إسرائيل إلى اتهام حماس بعرقلة تسليم جثث الأسرى. وفي النهاية، باتت الأطراف جميعها رهينة للسياسات الأميركية ورغباتها.
من الصعب اعتبار أنّ الوسطاء لعبوا دورا فاعلا أو كبيرا في إدارة الأزمة، فلقد انحصر دورهم الحقيقي في نقل رسائل إنذار وتحذير لحركة حماس، مؤكّدين وجود نوايا إسرائيلية جادّة لاستئناف وتصعيد الحرب.
وبالتالي، كان جوهر عملهم هو التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتّب على عرقلة الاتفاق، خاصة في ظل احتمالية انفجار القوة الإسرائيلية وما يجلبه ذلك من تداعيات كبيرة، ممّا يؤكد عجز الوسطاء عن ممارسة ضغط مواز وفعّال على إسرائيل.
الأهداف الأميركية أبعد من مجرد وقف الحرب، فالولايات المتحدة الأميركية حتى الآن تتحدث عن عملية ترحيل الفلسطينيين وتسكينهم بأراضٍ عربية. ما يعني أنها تهدف إلى تفريغ غزة والسيطرة عليها ضمن بعدها الاستثماري من خلال وضع اليد على موقعها الجغرافي وحقول الغاز.
مشروع ترامب أعمق بكثير، ويتجاوز مجرد إنهاء الحرب، ولم يكن هذا سرًا. فالزيارات السياسية للإدارة الأميركية إلى
تل أبيب ليست مقتصرة على وقف القتال، بل ترتبط أيضًا بأهداف استثمارية واضحة. تتمثّل في تسليم نتنياهو غزة إلى إدارة ترامب لتتمكن من تنفيذ خططها الخاصة في القطاع.
تبدو حركة حماس في وضع صعب، ولا خيارات أمامها، لأنّ الإدارة الأميركية تمارس التهديد بفرض الخطة بالقوة العسكرية الإسرائيلية أو بالقوة الأميركية، والتهديدات المتوالية تشير إلى ذلك.
أمّا السلطة الفلسطينية، فوضعها ليس بأفضل من حركة حماس، ولا خيارات كثيرة لديها. فعلى الرغم من امتلاكها مشروعيه سياسية أعلى، وعدم مشاركتها في أحداث السابع من أكتوبر، إلا أنّ إسرائيل تمكنت من تقويض مشروعية الحركة السياسية الفلسطينية، وإضعاف السلطة واستغلال الحرب على غزة في الهجوم على القضية الفلسطينية بشكل كامل.
وقد اعتبرها نتنياهو فرصة تاريخية لتقييد حركة السلطة وجعلها تراوح في مساحة صغيرة. تمتلك السلطة الآن خيارات محدودة. يجب التوافق مع العرب وتحميلهم المسؤولية، مستفيدة من المقدرات الاقتصادية والمالية والسياسية، والنفوذ السياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية . المتاح الآن أمام السلطة هو تغليف نفسها بالغطاء العربي لحمايتها.

انطلقت السياسة الإسرائيلية منذ البداية على رهان رفض المقاومة للخطة لكنها فوجئت بموافقتها عليها، واستغلت إسرائيل ما قدمته المقاومة في بداية المفاوضات من تأخر في تسليم جثث الأسرى، في خلق عقبة أولى من خلال التشدد في نوع وعدد الأسرى الفلسطينيين من المؤبدات وغيرهم بهدف دفع حماس للتراجع عن قبولها.
وقامت إسرائيل بخروقات ممنهجة
لوقف إطلاق النار؛ ما تسبب بعدد من الشهداء والجرحى وتدمير مبانٍ، وقامت بتعذيب الأسرى الفلسطينيين خلال مراحل الإفراج لذات الهدف أيضًا.
برزت محاولات إسرائيلية لـعرقلة وتأخير إدخال المساعدات، بالتوازي مع طرح فكرة ربط الإعمار بالسيطرة الإسرائيلية. يتمثل هذا الطرح في أن الإعمار سيقتصر على المناطق الخاضعة للاحتلال "ما وراء الخط الأصفر"، مع استثناء المناطق التي تتواجد فيها حماس، وهو ما وافقت عليه الإدارة الأميركية.
هذا يتعارض مع الخطة الأصلية التي تفترض الانسحاب الكامل لإسرائيل في المراحل اللاحقة. كما وضعت إسرائيل عراقيل أمام دخول المعدات الثقيلة وفرق الإنقاذ التركية، وبدأت بـالتحفظ على مشاركة تركيا ومصر وقطر في قوات حفظ السلام. هذه السلوكيات تعطي مؤشّرًا واضحًا على استمرار النهج الإسرائيلي المعيق في المرحلة النهائية من الخطة.
في المقابل، نجح الجانب الفلسطيني بعد التشاور مع الوسطاء، والفصائل الفلسطينية بإلقاء كرة النار المخزونة في قلب الخطة إلى حضن إسرائيل، وكسبت الجولة الأولى من تأييد الدول العربية والإسلامية الثمانية التي تبنت مفردات تصريح حركة حماس تمامًا، كما اضطرت الإدارة الأميركية والرئيس ترامب إلى الترحيب بذلك.
وبدأ مسار التفهم للمواقف والسياسات والمطالب الفلسطينية الأخرى تدريجيًا وبشيء من الاضطراب.
كما اتبعت المقاومة سياسة تطبيق الخطة فيما عرف بالمرحلة الأولى. ما أعطاها مصداقية الالتزام ووفر لها بيئة قابلة للتفهم والتفاهم على كثير من البنود الحساسة دون منح إسرائيل الذريعة.
تمثل دور الوسطاء الثلاثة بما يمكن أن يسمى بالدور المساعد لوقف الحرب ووقف المجاعة وربما لاحقًا في إعادة الإعمار. وقد أدّوا، وما زالوا، دورًا مهمًا في إقناع الإدارة الأميركية بأن الخيار العسكري لا يحقق ما تزعمه إسرائيل، وأن توفير غطاء أميركي لها للعودة إلى حرب
الإبادة الجماعية لا يخدم مصالحها في المنطقة، وقد أحرج حلفاءها.
كان دور الوسطاء محفّزا للاتفاق، ومعززا لتحصيل ضمانات أميركية لوقف الحرب. أضف إلى ذلك بروز دور عربي وإسلامي مساعد للمقاومة الفلسطينية في بلورة تصوراتها ومواقفها تجاه الخطة وآلية التعامل معها ومراحل تنفيذها.
سعت الولايات المتحدة من خلال الخطة لإنقاذ إسرائيل من نفسها وهي تعيش عزلة دولية متصاعدة وخانقة، وتطارد في العالم بجرائم حرب، وكذلك محاولة إحياء عملية السلام والتطبيع مع إسرائيل، ومحاولة تحقيق أهداف صفقة القرن السابقة بخصوص بناء شرق أوسط تكون فيه إسرائيل حجر الزاوية الأمنية والاقتصادية.
أرى أنّه من الصعب جدًّا فرض خطة ترامب أو غيرها على الشعب الفلسطيني، فقد جرت محاولات تاريخية كبيرة ولم تنجح لأن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار، والمقاومة بأشكالها كافة هي جزء من الثقافة الشعبية.
يبدو أن الهدف الأساسي من القبول بالمبادئ الأساسية لخطة ترامب هو وقف حرب الإبادة. ورغم ذلك، فإنّ العديد من النقاط الواردة في الخطة ستكون موضع نقاش وتفاوض مكثف لتحديد كيفية تطبيقها بما يضمن تحقيق المصلحة الفلسطينية.
وتُعدّ مسألة السلاح الفلسطيني قضية وطنية محورية، وأي مقترح يتعلق بها سيكون مرهونًا بتحصيل الحقوق الفلسطينية كاملة. ولهذا، يبدو من الضروري تأجيل بحث هذا الموضوع لحين ترسيخ المرجعية الوطنية والحصول على اعتراف دولي بالكيانية السياسية الفلسطينية.
بالنسبة لخيارات السلطة، فالخيار هو التوافق والتفاهم على كيفية إدارة المرحلة بشكل جماعي ولمصلحة الشعب الفلسطيني، خاصة وأنّ حماس وفتح قبلتا خطة ترامب بمبادئها الرئيسة، وبالتالي على الجميع أن يسعى لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار ووقف المجاعة في القطاع والالتصاق بالمواقف والحاضنة العربية والإسلامية والإقليمية والدولية التي تعززت في ظل هذه الحرب.

البصمات الإسرائيلية التي وضعت على خطة ترامب أضفت مزيدًا من الإبهام والغموض على عدد من القضايا الرئيسة، بحيث تصبح مواقع الغموض هذه أقرب إلى كونها ألغامًا يستطيع نتنياهو تفجيرها متى شاء. خاصة أنّ الخطة منحت إسرائيل مطالبها الرئيسة (الأسرى الأحياء والأموات، ونزع سلاح حماس) بشكل مسبّق ومعجّل، بينما جاءت المطالب والحقوق الفلسطينية مؤجلة أولًا، ومبهمة ثانيًا.
وهذا ما ينطبق على موضوعات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي الذي سيجري دائمًا "بالاتفاق" أي بالموافقة الإسرائيلية على كل شيء وعلى قضيتي إعادة الإعمار ودخول المساعدات. ولم تخفِ إسرائيل أنها معنية بشكل أساسي في إتمام المرحلة الأولى، على أن تتحكم بالمراحل اللاحقة بناء على حساباتها ومصالحها الأمنية، وفوق كل ذلك مصلحة نتنياهو السياسية.
تركزت السياسة الإسرائيلية في تطبيق المرحلة الأولى على المراوغة والتلاعب ببنود الاتفاق، بهدف تأجيل المراحل التالية والمماطلة في تنفيذها لشهور أو سنوات. وقد تجسد ذلك عملياً في اختلاق الذرائع، مثل تأخير تسليم الجثث، لتبرير إلغاء أو تأجيل الالتزامات الإسرائيلية.
فعليًا، قامت إسرائيل بـإغلاق
معبر رفح، ووقف المساعدات، واستئناف الهجوم الواسع واستهداف عشرات الأهداف وإيقاع العشرات من الشهداء، متذرّعة بتأخير تسليم الجثث. كما راهنت إسرائيل على تضاؤل اهتمام ترامب بتطبيق المراحل اللاحقة، مما يمنحها قدرة أكبر على التحكم في تفسير وتوقيت هذه المراحل، ويبرز رهانها على عامل الزمن والتحوّل المحتمل في المواقف الأميركية والدولية.
كانت المقاومة تسير بحذر شديد، "كمن يسير على خيط مشدود"، مركّزة كل اهتمامها على وقف حرب الإبادة وضمان صمود وبقاء الشعب على أرضه. ولهذا السبب، لم يكن بمقدورها رفض خطة ترامب أو إبداء تحفظات عليها؛ لأن أي رفض كان سيمنح نتنياهو مبررًا دوليًا وإقليميًا لمواصلة الحرب واستئنافها.
وفي نفس الوقت من الصعب على المقاومة الموافقة على الخطة كما هي؛ أي بكل ما فيها من ثغرات ومساوئ. لذلك خرجت المقاومة بذلك الموقف الدقيق والحذر الذي لم ينسَ دغدغة الأنا المنفوخة والمتضخمة لدى ترامب التي يبدو أنها عنصر رئيس خلف سياساته ومواقفه.
وفي إطار ذلك اعتمدت المقاومة سياسة الالتزام التام بتطبيق المرحلة الأولى وقد فعلت ذلك، لكنها امتنعت عن تقديم أجوبة واضحة وقاطعة بشأن وضع السلاح (أو نزعه)، وكان جوابها كافيًا لكي يرحب به ترامب ويعتبر أنها وافقت على الخطة.
انطلق موقف المقاومة من مبدأ مصلحة الشعب أولًا. فهي ترى أنّ سلاحها لا يعتمد على إمكانياتها العسكرية المادية في المرحلة الحاليّة، لأنّ المقاومة تعتمد على إرادة الناس في جوهرها. والأهمّ من ذلك، أنّ المقاومة تعتقد أنّ القيادة الفلسطينية، والوسطاء، والمجتمع الدولي يمتلكون القدرة على التدخل والتأثير في المفاوضات لتوضيح القضايا الغامضة والملتبسة، لمنع إسرائيل من الانفراد بتفسيرها.
أمّا دور الوسطاء، فهو يعتمد عليهم وعلى قدرتهم على استثمار وزنهم السياسي والاقتصادي وعلاقاتهم بالولايات المتحدة، ووجود وسطاء عرب وإقليميين يحقق مكسبًا للفلسطينيين بعدم ترك المجال لـإسرائيل للاستفراد بالشعب الفلسطيني، وكأن الأمر هو شأن داخلي إسرائيلي (وهذا المعنى للأسف كان كامنًا في الاتفاقيات الإبراهيمية).
لعبت دول الوساطة وخاصة مصر وقطر دورا رئيسًا في التهدئة، خاصة أنّ إسرائيل تريد حصر دور دول الوساطة بالتمويل والأمن من دون التأثير على مستقبل القضية الفلسطينية. تستطيع دول الوساطة الآن أن تلعب دورا سياسيًّا رئيسًا، وهي تدرك أن خطة ترامب ليست مجرد ترتيبات مالية وأمنية.
وقد لمسنا نجاحا واضحًا لدول الوساطة في تراجع الإدارة الأميركية عن مخطط التهجير، ولجم التطلعات الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة
والاستيطان فيها. وتجلّت في الإقرار الضمني من إدارة ترامب بالمبدأ الذي قامت عليه خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر وتبنتها القمة العربية الإسلامية.
هناك قضية مهمة ما زالت غامضة، ففي تبني الخطة السعودية الفرنسية لمسار موثوق لحل الدولتين، يجري التعامل مع
الدولة الفلسطينيةكطموح مشروع، وليس حقًا أصيلًا مكفولًا دوليًا. ويزيد الأمر تعقيدًا غياب الإشارة الحاسمة لمنظمة التحرير والسلطة كممثلين للفلسطينيين، وكذلك وحدة الأراضي الفلسطينية.
ونظرًا لأنّ مخططات نتنياهو لتصفية القضية تهدّد سلامة وسيادة دول المنطقة، ولأنّ للولايات المتحدة الأميركية مصالح كبيرة فيها، يمكن لدول الوساطة والمجموعة العربية والإسلامية استغلال هذا النفوذ لفرض تأثيرات حاسمة على تفسيرات خطة ترامب.