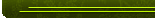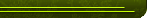عملية "سلامة الجليل" وخلفياتها
مثل عام 1981 ذروة التوتر وتصاعد الأحداث، ففي يوليو/تموز من ذلك العام اندلع اشتباك استمر لعدة أيام حين قصفت إسرائيل مواقع فلسطينية في الجنوب، وردت مدفعية المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات الجليل، ويبدو أن هذه المواجهة كشفت استعداد إسرائيل المبكر لتوسيع عملياتها، وأنها كانت أشبه بالبروفة الأولى لاجتياح واسع وقع فيما بعد.
انتهت تلك المواجهات في ذلك العام بوساطة المبعوث الأميركي
فيليب حبيب، الذي أبرم اتفاق تهدئة بين الطرفين، غير أن تل أبيب رأت في هذه التهدئة فرصة مؤقتة لا أكثر، إذ صرح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك
أرئيل شارون أن وجود منظمة التحرير على حدود إسرائيل أمر غير مقبول، والتهدئة مجرد غطاء لزيادة تسليحهم.
وقد دل هذا التصريح على أن فكرة الاجتياح كانت مطروحة بالفعل في ذهن القيادة الإسرائيلية منذ وقت مبكر، حيث أورد تقرير نشره عقيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي بصحيفة هآرتس في مايو/أيار 2014 أن شارون كان قد خطط لاجتياح بيروت قبل الحرب بعدة أشهر لربط مسيحيي الشمال اللبناني بجنوبه، وطرد
منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.
وجاءت الشرارة لتنفيذ هذه الخطة في الثالث من يونيو/حزيران 1982، حين تعرض السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف لمحاولة اغتيال نفذتها منظمة يقودها الفلسطيني
أبو نضال، وكانت قد انشقت عن منظمة التحرير، ورغم إعلان منظمة التحرير تبرؤها من تلك العملية، فإن الحكومة الإسرائيلية استغلت الحادثة كذريعة.
وهنا يذكر الصحفي عوزي بنزيمان في شهادته أن شارون استغل ثقة رئيس الوزراء
مناحيم بيغن في توجيهه لإطلاق العملية، وفي اليوم التالي قررت إسرائيل قصف مواقع في بيروت والجنوب اللبناني، ثم أعلنت في السادس من يونيو/حزيران بدء عملية أطلقت عليها "سلامة الجليل"، وكان الهدف المعلن كما جاء في خطاب بيغن أمام
الكنيست إبعاد منظمة التحرير عن حدود إسرائيل 40 كيلومترا للوراء.
لكن الهدف الفعلي -كما توضح لجنة كهانا التي حققت لاحقا في الحرب عرف بتقرير 1983- كان أبعد من ذلك، حيث تمثل في إخراج منظمة التحرير بقيادة
ياسر عرفات من لبنان بالكامل وإضعاف النفوذ السوري هناك، مع تمهيد الطريق لتوقيع معاهدة سلام مع حكومة لبنانية موالية لإسرائيل.
وفي وسط تلك التطورات، وبدء العملية العسكرية الإسرائيلية
واجتياح لبنان، برزت أهمية معركة الشقيف، فبحسب معين الطاهر في مقالته "معركة قلعة الشقيف 1982: روايتان"، فإن القيادة الإسرائيلية رأت في السيطرة على القلعة رمزا يبرر للجمهور الداخلي حجم التضحية، بينما رأت منظمة التحرير أن الدفاع عنها دفاع عن الكرامة الفلسطينية والعربية، وأن سقوطها المبكر سيعطي الانطباع بأن الاجتياح سيمر بلا مقاومة.
الشقيف أو "قلعة بوفور" كما يسميها الإسرائيليون، تقع على تلة صخرية قرب مرجعيون، وتطل على
نهر الليطاني وتكشف الجليل الأعلى بكل وضوح، هذا الموقع جعلها هدفا إستراتيجيا إسرائيليا منذ بدايات
الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ولهذا السبب تناولها الجغرافيون العرب والمسلمون بالوصف وإبراز الأهمية.
وقد برز دورها الضخم في زمن
الحروب الصليبية حين احتلها الصليبيون وأشرفوا على الأراضي العربية المحيطة بها، واتخذوها منطلقا للهجمات على المنطقة طوال عقود.
ولهذا الموقع حصانة إستراتيجية جعلته هدفا مبكرا للقوات الإسرائيلية مع بداية
اجتياح لبنان في يونيو/حزيران 1982، إذ دفعت تل أبيب وحدات من
لواء غولاني نحو قلعة الشقيف في الليلة الأولى للعملية.
وكانت المقاومة الفلسطينية قد رسخت وجودها في القلعة منذ ما بعد هزيمة 1967، فتحولت إلى أحد مراكزها العسكرية البارزة في الجنوب اللبناني، وفي تلك الفترة أوكلت القيادة الميدانية إلى الفلسطيني يعقوب سمور، المعروف باسمه الحركي "راسم"، يسانده مقاتلون من "كتيبة الطلاب" ومن صفوف "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".
وقد وفّر الموقع للمقاومين شبكة من الأنفاق والمخابئ الإسمنتية، مما أتاح لهم مرونة في الحركة تحت القصف الكثيف، ويشير معين الطاهر في مقالته السابقة التي قارن فيها بين الرواية الإسرائيلية والرواية الفلسطينية لمعركة الشقيف إلى أن المقاتلين كانوا يتنقلون من غرفة إلى أخرى عبر ممرات ضيقة، يطلقون النار ثم يعودون للاختباء، في وصف يوضح الطابع العصيب لحرب الأنفاق والدشم التي ميّزت صمود القلعة.
ورغم شراسة القصف الإسرائيلي الذي وُصف حينها بالجنوني، فإن صفوف المقاتلين لم تتعرض لأي إصابات مباشرة، وهو ما يُعزى إلى شبكة التحصينات المحكمة التي جرى إعدادها مسبقا.
وساهم المئات من أبناء المخيمات الفلسطينية وطلبة الجامعات اللبنانية رجالاً ونساء، في أعمال حفر الخنادق والأنفاق وربطها ببعضها البعض، في حين تولى طلاب الهندسة الإشراف الفني على هذه الأعمال طوال أشهر سبقت الاجتياح.
وقد تمت هذه الجهود تحت قيادة الفدائي الفلسطيني الذي استُشهد فيما بعد علي أبو طوق، حيث وضع خطة دفاعية متكاملة شملت بناء دشم ومتاريس متينة، مكّنت المقاتلين من الصمود أمام القصف، ومنحتهم مواقع أكثر أمانا وقدرة على خوض الاشتباكات المباشرة مع
القوات الإسرائيلية.
تكشف الروايات العسكرية الإسرائيلية عن حجم الصدمة التي واجهتها وحداتها في معركة قلعة الشقيف في يونيو/حزيران 1982، فقبل وصول قوة الاستطلاع إلى تخوم القلعة، انهالت عليها نيران كثيفة أصابت قائدها موشيه كابلينسكي بجراح خطيرة وأجبرت القوات على التوقف وإعادة تنظيم صفوفها.
وتصف رواية الصحفي الإسرائيلي زئيف شيف في تقاريره كيف تلقت القيادة الميدانية تباعا أنباءً عن إصابة قادة الكتائب والسرايا واحداً تلو الآخر، إذ أصيب قائد الكتيبة الشرقية بجروح خطيرة، في حين قُتل مرافقه، وسرعان ما تبين أن اثنين من قادة السرايا أصيبا بدورهما، قبل أن يأتي الخبر الأشد المتمثل في إصابة كابلينسكي نفسه برصاصة في صدره وتولي مردخاي غولدمان الشهير بـ"موتي" القيادة مكانه.
ومع دخول
لواء غولاني إلى أرض المعركة انقسمت القوة إلى جناحين، حيث التف الجناح الأول حول القلعة لمهاجمة مواقع المقاومة في أرنون وكفر تبنيت لكنه وقع في حقل ألغام، بينما اندفع القسم الآخر عبر طريق أرنون المؤدي مباشرة إلى القلعة، وهناك واجه الإسرائيليون مقاومة ضارية ترافقت مع قصف متواصل دمّر عدداً من العربات العسكرية بينها عربة الرائد جوني هرنيك قائد الهجوم الجديد، الذي قُتل مع سائقه وأحد مساعديه.
ولم يجد هرنيك بدا من إصدار أمر إلى جنوده بترك العربات والتقدم سيرا على الأقدام، لكن ما إن صعدوا بضعة أمتار حتى فتحت عليهم النيران بكثافة، ووفق ما نقلته القناة العاشرة الإسرائيلية على لسان أحد الجنود بدا المشهد كأن "أبواب جهنم قد فُتحت"، ليسقط هرنيك وعدد كبير من جنوده قتلى في لحظات قصيرة، وفي الوثائقي المصور على القناة العاشرة الإسرائيلية الذي بثته في عام 2013، يظهر الطبيب المرافق للقوة وهو يصرخ بمرارة: "لم يبق أحد".
دفعت هذه الخسائر الجيش الإسرائيلي إلى إرسال قوة جديدة بقيادة المقدم دوف، لتستمر المعركة على مدار 60 ساعة كاملة من القتال المتلاحم من خندق إلى خندق، حتى وصلت في بعض مراحلها إلى الاشتباك بالسلاح الأبيض وبالأيدي.
مقاتلان
ويروي الناجون الإسرائيليون أن اثنين من المقاتلين الفلسطينيين واصلا القتال بمفردهما 12 ساعة إضافية حتى استشهدا صباح يوم الاثنين السابع من يونيو/حزيران، بعد أن قتلا 7 جنود وأصابا 17 آخرين بجروح.
وقد اعترف مردخاي غولدمان في شهادته أن "المعركة لم تكن متكافئة"، مؤكدا أن المقاتلين في القلعة لم يُبدوا أي نية للاستسلام، بل قاتلوا حتى الرمق الأخير دفاعا عن الموقع.
كانت المهمة الأساسية لوحدات الهندسة الإسرائيلية الاستيلاء على الموقع الجنوبي، وتقدّم غولدمان مع 21 جنديا نحو الموقع الشمالي عبر طريق متعرج صاعد لمسافة 150 مترا، لكن سرعان ما اكتشف أن النيران تتفجر من 3 أو 4 مواقع محصنة، وحين التفت خلفه وجد أن نصف رجاله قد سقطوا خلال التقدم، ومع ذلك جاءه أمر صريح بالاستمرار.
وقد تسببت نيران الرشاشات الثقيلة في مقتل جنود إضافيين في حين أُصيب 4 آخرون بجراح بليغة، ولم يصل إلى الهدف سوى غولدمان و3 من رفاقه، لكنهم أيضا تعرضوا بدورهم لرشقات نارية وقنابل يدوية أنهت حياة بعضهم، ورغم محاولة غولدمان سحب زميله الجريح رازي إلى الخلف، فقد انفجرت قنبلة قربهما أنهت حياته في الحال.
تحدثت الرواية الإسرائيلية الرسمية أيضا عن وجود 27 مقاتلا فلسطينيا في القلعة استشهدوا جميعا، ووصفتهم بأنهم "مقاتلون بارعون لم يفكر أحد منهم في الاستسلام"، معتبرة أن المعركة بالنسبة لهم كانت "مسألة كرامة"، أما القائد الإسرائيلي أشكنازي فقد أسهب في وصف أجواء الليل الطويل قائلاً: "قضينا ساعات ونحن لا نعرف من أين يطلقون النيران، كانت تأتي من كل مكان".
 اليوم التالي والنهاية
اليوم التالي والنهاية
وفي صباح الاثنين السابع من يونيو/حزيران 1982، حطّت مروحية عسكرية فوق قلعة الشقيف وهي تقل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رفائيل إيتان، وسرعان ما تبعه وزير الدفاع أريئيل شارون ترافقه مجموعة كبيرة من المصورين، ولم يكن أي منهما على دراية دقيقة بحجم الخسائر البشرية التي تكبدتها
القوات الإسرائيلية في المعركة، فبادر شارون إلى إعلان أن المواجهة "لم تسفر عن وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي".
لكن صمته لم يطل، إذ ردّ عليه ضابط شاب برتبة ملازم ثانٍ قائلا: "ماذا جرى لكم؟ هنا حيث تقف قُتل 6 من رفاقي". فوجئ شارون بهذا الرد الصادم، وما لبث أن وصل رئيس الوزراء مناحيم بيغن هو الآخر من دون علم مسبق بما دار في القلعة.
يورد الفيلم الوثائقي الإسرائيلي أيضا مشهدا دالا على حجم الفجوة بين القيادة والجنود، فقد خاطب بيغن وزير دفاعه قائلاً: "إن هواء التلال منعش… هل جرت معركة هنا؟"، فردّ شارون وهو في حالة من الصدمة: "جنودنا أعمارهم صغيرة… لقد حاربوا هنا"، متجنباً التصريح بعدد القتلى.
وفي مواجهة مباشرة أمام الكاميرات، سأل بيغن أحد الجنود: "هل كان لديهم بنادق؟"، فأجاب الجندي بمرارة: "كثير من البنادق".
ثم تابع بيغن بسؤال آخر: "هل استسلم أحد؟"، فجاء الرد غاضباً والدموع تترقرق في عيني المقاتل: "لم يستسلم أحد منهم"، وكررها: "لم يستسلم أحد".
وكما يذكر معين الطاهر في مقالته السابقة، وهو في الوقت ذاته قائد كتيبة الجرمق في حركة
فتح، وهي الكتلة الأبرز التي حارب عدد من رجالاتها في معركة الشقيف هذه، في شهادته ونقله للروايتين الإسرائيلية والفلسطينية، فقد كانت الأرض تحت أقدام القادة الإسرائيليين مغطاة بأعيرة الرصاص الفارغة، في مشهد لم يترك مجالاً للإنكار.
وبحسب تعليق المراسل الإسرائيلي في الوثائقي أدرك بيغن في تلك اللحظة حجم الكارثة؛ إذ التفت نحو شارون بنظرة صامتة، فبادر الأخير قائلاً: "لماذا جئت إلى هنا… القتال ما زال قريباً". خرج بيغن من الموقع مثقلاً بخيبة واضحة، ولم يعد بعدها إلى لبنان طوال فترة الحرب، مكتفياً بتلقي التقارير من بعيد.
ويستكمل أحد الجنود شهادته ليصف كيف أن لحظة مغادرة بيغن وشارون لم تخلُ من مفارقة دامية؛ إذ يروي: "بعد دقائق فقط أطلق أحد الفدائيين الجرحى من بين الأنقاض بضع رصاصات قبل أن يلفظ أنفاسه"، ثم يضيف متسائلاً: "تخيلوا لو حدث ذلك قبل دقائق؟".
ومن اللافت أن هذه الشهادات سواء في مذكرات زئيف شيف أو في وثائقيات القناة العاشرة الإسرائيلية، لا تُبرز فقط صعوبة السيطرة على موقع إستراتيجي كقلعة الشقيف، بل أيضا تكشف عن طبيعة المقاومة الفلسطينية التي تمكنت من تحويل القلعة إلى رمز للصمود، حيث تقاطعت شجاعة المقاتلين مع تضاريس المكان لتصنع ملحمة عسكرية ما زالت تثير الجدل في الأرشيف العسكري الإسرائيلي حتى اليوم.
وفي المحصلة فإن معركة الشقيف عام 1982 صحيح أنها لم تغيّر مسار الحرب
والاجتياح الإسرائيلي للبنان، لكنها جسدت صمود المقاومة الفلسطينية قليلة العدد التي بلغت على أقصى تقدير 30 مقاوما بذلوا أنفسهم حتى آخر نفس، أمام جيش مكون من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والمجنزرات والدبابات، ولهذا السبب بقيت الشقيف جزءا من الذاكرة الفلسطينية والعربية، وربما الإسرائيلية أيضا.