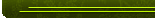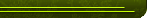الحصار والدك!
الحصار والدك!
لم تكن حملة الأشرف خليل مجرد تحرك عسكري تقليدي، بل أقرب ما تكون إلى مشروع وطني شامل جرى فيه استنفار مختلف الطاقات البشرية والمادية، فالمهندسون والأطباء والبناؤون والحجّارون، ومعهم الصناع من شتى الحرف انضموا إلى الجيش بوصفهم قوات مساندة، في صورة تعبّر عن وعي الدولة المملوكية بضرورة تعبئة فئات المجتمع كله خلف مشروع التحرير؛ ولأن البحر كان دائما ميدانا حاسما في المعارك مع الصليبيين، حرص الأشرف خليل على إعداد قوة بحرية ضخمة، فقد جهّز أسطولا حربيا قوامه ستّون قطعة بحرية، أبرزها السفن الكبيرة التي عُرفت آنذاك بـ"الشواني"، لتكون ذراعا حاسمة في خنق عكا من البحر.
غير أن السلطان خليل لم يغفل البُعد الروحي، فكان حريصا على إشراك الناس في جوّ من التعبئة الدينية والإيمانية التي ترفع الروح المعنوية، حيث وزّع الأموال والثياب على الفقراء والقراء، وحثّ المجتمع على المشاركة، حتى وصف المؤرخ علم الدين البِرزالي في تاريخه هذه الأجواء قائلا: "وعُملت ختمة بجامع دمشق ليلة الجمعة السابع عشر جمادى الأولى، وتضرّع الناس إلى الله تعالى، واجتمعت قلوبهم، ودعا الخطيب يوم الجمعة، وفُتحت عكّا في يوم الجمعة".
هذا المناخ سمح بانخراط العامة والمتطوعين إلى جانب الجيوش النظامية، فشارك الجمّالون وأهل الأسواق وحتى العلماء والمدرسون في دفع آلات الحصار، ويصف المؤرخ والمحدِّث ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" ذلك المشهد بقوله: "جاء البريد إلى دمشق في مستهل ربيع الأول [سنة 690هـ] لتجهيز آلات الحصار لعكا، ونودي في دمشق: الغزاة في سبيل الله إلى عكا… فأُبرزت المجانيق إلى ناحية الجسورة، وخرجت العامة والمطوعة يجرون في العجَل، حتى الفقهاء والمدرسون والصلحاء… وخرج الناس من كل صوب، واتصل بهم عسكر طرابلس، وركب الأشرف من الديار المصرية بعساكره قاصدا عكا، فتوافت الجيوش هنالك، فنازلها يوم الخميس رابع ربيع الآخر، ونُصبت عليها المجانيق من كل ناحية يمكن نصبها عليها، واجتهدوا غاية الاجتهاد في محاربتها والتضييق على أهلها".
وكانت التعبئة شاملة إلى حدٍّ غير مسبوق، فقد بلغ تعداد الجيش المملوكي أكثر من 160 ألف مقاتل، يضاف إليهم ستّون ألفًا من المشاة، وتنوعت مكونات هذا الحشد بين الجنود النظاميين والعناصر القادمة من القبائل العربية والأكراد والتركمان والجركس، وقد ساعد طول الفترة الفاصلة بين نقض الصليبيين للهدنة واستعداد السلطان المنصور قلاوون، منذ شوال سنة 689هـ، على تهيئة المناخ اللازم لجمع هذا الحشد الهائل من الرجال والعتاد حتى انطلق الحصار في ربيع الأول سنة 690هـ.
حين وصلت الجيوش المملوكية إلى مشارف عكا في أوائل ربيع الآخر سنة 690هـ، كان المشهد أشبه بختام قرنين من الصراع المتواصل أمام الصليبيين، فلم يعد الأمر مجرد معركة لتحرير مدينة ساحلية، بل تحوّل إلى مشروع جماعي يجسّد ذاكرة المسلمين الجمعية وما عانوه من مذلة واضطهاد ونهب وقتل وأسْر في حواضر الشام التي سيطر عليها الصليبيون.
وكما نرى عند المؤرخين العيني والمقريزي وابن كثير وأبو الفداء وغيرهم في عرضهم لتفاصيل هذه المعركة الحاسمة، فقد أحاطت القوات الإسلامية بالمدينة من جهاتها البرية، بينما بقي البحر خلف عكا يحمي ظهرها، وكما هي عادة المماليك، فقد انقسم الجيش إلى ثلاث فرق رئيسية:
الميمنة التي تولّاها الملك المظفر بن المنصور صاحب حماة، فكانت مسؤولة عن مواجهة الأسطول الصليبي في عرض البحر إلى جانب التصدي لحاميات الأسوار والأبراج، وقد شهدت هذه الجبهة أشد الاشتباكات، حتى إنّ فرسان الداوية شنّوا هجوما ليليا مباغتا عليها، لكن قوات المظفر أفشلته وأَسرت عددا من المهاجمين.
والميسرة التي قادها الأمير المخضرم بدر الدين بِكتاش، وتمركزت في الجهة الجنوبية الغربية من خليج عكا.
أما القلب ومركز العمليات فقد انتشرت فيه بقية القوات المملوكية، في حين نَصب السلطان الأشرف خليل خيمته العسكرية ومركز القيادة قبالة البرج البابوي بين الوسط والميسرة، على مقربة من ساحل المتوسط في منطقة مرتفعة، ليكون في قلب الحدث ويسيطر على مجريات الحصار.
وقد بنى المماليك خطتهم على الجمع بين استنزاف الخصم بالسهام والنُشّاب من بعيد، وبين استخدام آلات النقب ودكّ الأسوار الثقيلة لكسر تحصينات المدينة، التي تكونت من 92 منجنيقا بمختلف الأحجام نُصبت حول الأسوار بدقة متناهية، كانت ترسل ليلا ونهارا الأحجار الضخمة والقوارير المملوءة بالنفط، فتحوّلت الأبراج والمنازل داخل عكا إلى أنقاض خلال 44 يوما متواصلة من القصف، حينها كان المهندسون والحجّارون يبحثون باستمرار عن نقاط ضعف في الأسوار لفتح الثغرات، فيما تكفلت النيران بإشعال الرعب داخل عكا.