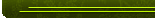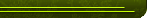في المقابل، يرى بعض المسؤولين الصينيين أن الغياب عن ميادين القتال لا ينبغي أن يُعد مؤشرًا على الضعف بالضرورة، ويستشهدون بجيوش كبرى لم تخض حروبا متكررة، لكنها أثبتت كفاءتها حين اندلعت المواجهة.
ومع ذلك، يبقى السؤال معلّقا: هل بوسع هذه القوة الجوية الضخمة أن تُحقق تفوقا حقيقيا إذا اندلع نزاع واسع النطاق؟ أم أنها، رغم مظهرها المهيب، مجرد أداة ردع رمزية قد تنكشف عند أول اختبار عن عملاق من ورق؟

لفهم إستراتيجية سلاح الجو الصيني في صورتها المعاصرة، لا بد من العودة إلى الجذور الفكرية التي شكّلت عقيدة الصين العسكرية، وفي مقدمتها مبدأ "الدفاع النشط"، الذي تعود أصوله إلى عهد
ماو تسي تونغ.
ففي عام 1928، قدّم ماو صياغته الشهيرة لتكتيكات
حرب العصابات: "عندما يتقدم العدو؛ نتراجع. عندما يعسكر؛ نُزعجه. عندما يتعب؛ نهاجمه. وعندما يتراجع؛ نلاحقه". كانت تلك المقولة تجسيدًا واضحًا لرؤية عسكرية تمزج بين "الكُمُون الإستراتيجي" و"الهجوم المضاد المرن"، بهدف الحفاظ على زمام المبادرة في مواجهة خصم يتفوق عددا وعتادا.
وقد تمثّل التطبيق العملي الأبرز لهذا النهج في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، من خلال تبنّي سياسة "استدراج العدو إلى العمق"، وهي إستراتيجية تقوم على انسحاب منظّم نحو قواعد خلفية، يهدف إلى إنهاك العدو تدريجيًّا، قبل مباغتته بهجوم مضاد حاسم يُكسَر به الحصار وتُدمَّر أجزاء من قوته. بهذا الشكل، تحوّل هذا الأسلوب من مجرد تكتيك ميداني إلى قاعدة مركزية لعقيدة "الدفاع النشط" بوصفها رؤية إستراتيجية متكاملة.
ألقت هذه المرحلة التاريخية بظلالها العميقة على بنية الجيش الصيني، بما في ذلك سلاح الجو. فكما يوضح شياو مينغ تشانغ، الأستاذ المشارك في قسم القيادة والإستراتيجية بكلية الحرب الجوية التابعة لسلاح الجو الأميركي، فإن التفكير الدفاعي الذي طبع العقيدة العسكرية الصينية دفع بكين إلى تشكيل قوة جوية ترتكز أساسا على عدد كبير من المقاتلات، لا القاذفات. ذلك أن المقاتلات تتماشى مع طبيعة العمليات الدفاعية، بينما تُستخدم القاذفات غالبا في ضرب العمق المعادي، وهو ما لم يكن متّسقا مع التوجّه الإستراتيجي الصيني في تلك المرحلة.
كذلك، نُظر إلى سلاح الجو بوصفه امتدادا تكتيكيا للقوات البرية، ينبغي بناؤه وفق متطلبات ساحة المعركة الأرضية، انطلاقا من اقتناع راسخ بأن الصين دولة برية في جوهرها. ومن هذا المنطلق، لم يُعامل سلاح الجو بوصفه قوة إستراتيجية مستقلة، بل أداة دعم للعمليات البرية، ويُقاس نجاحه بمدى فاعليته في إسناد القوات البرية، لا بقدرته على تحقيق أهداف جوية مستقلة.
وانعكس ذلك في العقيدة العسكرية، التي اعتبرت أن أي انتصار تحققه القوات البرية يُحتسب تلقائيا إنجازا يُسجّل لسلاح الجو أيضا، وهو ما كرّس تبعيته الهيكلية والوظيفية للجيش البري.
بيد أن
الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، مثّلت أول اختبار خارجي فعلي لجدوى هذا التصور، وحينها أدرك القادة الصينيون مدى تفوّق القوات الجوية الأميركية.
لكنهم رغم ذلك، لم يعيدوا النظر في البنية الإستراتيجية لسلاحهم الجوي بشكل جذري، بل ظلّ الرهان منصبّا على العنصر البشري، تأثرا بإرث حرب العصابات، وهو ما عزّز مكانة سلاح الجو داخل المؤسسة العسكرية، دون أن يمنحه استقلالًا إستراتيجيا حقيقيا، بل أبقاه في موقع القوة التكميلية التابعة للجيش البري.